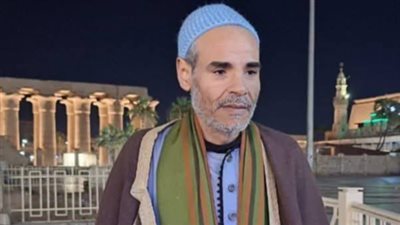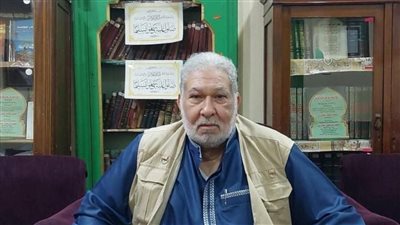طلب المدد من الأولياء: شرك أم توسل مشروع؟..الإفتاء تحسم القضية

طلب المدد من الأولياء، واحدة من الأمور التي أثارت الجدل في الساعات القليلة الماضية، وفي بيانها شددت دار الإفتاء على أن طَلَبَ المسلمِ المددَ من الأولياء والصالحين أحياءً ومنتقلين يُحمَل على السببية لا على التأثير والخلق؛ حملًا لأقوال المسلمين وأفعالهم على السلامة على ما هو الأصل.
طلب المدد من الأولياء.. حكمه ومعناه وهل يعد شركًا؟
وبينت يكون ذلك -في حق المتوفين منهم- على قصد الدعاء وغيره مما أُذِنَ لهم فيه؛ كما ورد في الأنبياء وغيرهم من العبادة والدعاء والتصرف في الحياة البرزخية، ومن ذلك:
- صلاة سيدنا موسى عليه السلام في قبره.
- وائتمام الأنبياء والمرسلين بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج.
- وحديث الأعمى الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ» رواه الترمذي، وابن ماجه، والنسائي وصححه جمع من الحفاظ، وعند الطبراني وغيره أن راوي الحديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه عَلَّم هذا الدعاء لمن طلب منه التوسط له في حاجة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى.
- وروى ابن أبي شيبة من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار -وكان خازن عمر رضي الله عنه- قال: "أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، استَسقِ لأُمَّتك، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقال: ائتِ عمر فأقرئه مني السلام وأخبره أنكم مُسقَون، وقل له عليك الكَيس، قال: فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رب، ما آلو إلا ما عجزت عنه"، وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
- وذكر الإمام الطبري في "تاريخه" في الكلام على أحداث معركة اليمامة: أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وقف بين الصفين ودعا للبِراز، وقال: أنا ابن الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد، ثم نادى بشعار المسلمين وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه، وجعل لا يبرز له أحد إلا قتله.
وبينت أن دعوى الخصوصية في ذلك كله خلاف الأصل، بل يدل على عدم الخصوصية: ما جاء في الحديث المرفوع عند الإمام ابن عبد البر وغيره: «مَا مِنْ أَحَدٍ مَرَّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» "الاستذكار"، ومن المعلوم أن السلام دعاء، وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ» أخرجه الطبراني وأبو يعلى، ونحوه عند البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «إِنَّ لله مَلائِكَةً فِي الأَرْضِ سِوَى الْحَفَظَةِ يَكْتُبُونَ مَا سَقَطَ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ فَإِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ عَرْجَةٌ بِأَرْضٍ فَلاةٍ فَلْيُنَادِ: أَعِينُوا عِبَادَ اللهِ» رواه الطبراني وحَسَّنه الحافظ ابن حجر في "أمالي الأذكار"، قال الإمام الطبراني عقب رواية الحديث: وقد جُرِّبَ ذلك.
وقد بسط الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب "الروح" الكلام على ذلك، وأيده بالنقول عن السلف الصالح فليراجع، ثم إن حصول المدد بعد ذلك إنما بأمر الله وحده، لا مانع لما أعطى ولا رادّ لفضله ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى جل شأنه وتبارك اسمه.
أما إقحام الكفر والشرك في هذه المسائل -كما يدندن كثير من الناس- فلا وجه له، اللهم إلا على افتراض أن طالب المدد يعبد مَن في القبر، أو يعتقد أنه ينفع أو يضر بذاته، وهذا الاحتمال ينأى أهل العلم عن حمل فعل المسلم عليها كما سبق؛ لأن فرض المسألة في المسلم الذي يطلب المدد لا في غير ذلك.
3 أمور شرعية تجعل التبرك وطلب المدد من الأولياء فعل مقبول شرعًا
أولًا: الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم أن تُحمَل على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، ولا يجوز أن نبادر برميه بالكفر أو الشرك؛ فإن إسلامه قرينةٌ قوية توجب علينا ألا نحمل أفعاله على ما يقتضي الكفر، وتلك قاعدة عامة ينبغي على المسلمين تطبيقها في كل الأفعال التي تصدر من إخوانهم المسلمين، وقد عبر الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: "مَن صدر عنه ما يحتمل الكفرَ من تسعة وتسعين وجهًا ويحتمل الإيمان من وجه حُمِل أمره على الإيمان"، ولنضرب لذلك مثلًا قوليًّا وآخر فعليًّا: فالمسلم يعتقد أن المسيح عليه السلام يحيي الموتى ولكن بإذن الله، وهو غير قادر على ذلك بنفسه وإنما بقوة الله وحوله، والنصراني يعتقد أنه يحيي الموتى، ولكنه يعتقد أن ذلك بقوة ذاتية، وأنه هو الله أو ابن الله، أو أحد أقانيم الإله كما يعتقدون.
وعلى هذا فإذا سمعنا مسلمًا موحدًا يقول: "أنا أعتقد أن المسيح يحيي الموتى" -ونفس تلك المقولة قالها آخر مسيحي- فلا ينبغي أن نظن أن المسلم تنصر بهذه الكلمة، بل نحملها على المعنى اللائق بانتسابه للإسلام ولعقيدة التوحيد.
ثانيًا: هناك فارق كبير وبون شاسع ما بين الوسيلة والشرك؛ فالوسيلة مأمور بها شرعًا في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 35]، وأثنى سبحانه على من يتوسلون إليه في دعائهم فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: 57]، والوسيلة في اللغة: المنزلة، والوصلة، والقُربة؛ فجِماع معناها هو: التقرب إلى الله تعالى بكل ما شرعه سبحانه، ويدخل في ذلك تعظيم كل ما عظمه الله تعالى من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال؛ فيسعى المسلم مثلًا للصلاة في المسجد الحرام، والدعاء عند قبر المصطفى صلَّى الله عليه وآله وسلَّم والملتزم تعظيمًا لما عَظَّمه الله من الأماكن، ويتحرى قيام ليلة القدر والدعاء في ساعة الإجابة يوم الجمعة وفي ثلث الليل الآخر تعظيمًا لما عظمه الله من الأزمنة، ويتقرب إلى الله بحب الأنبياء والأولياء والصالحين تعظيمًا لمن عظمه الله من الأشخاص، ويتحرى الدعاء حال السفر وعند نزول الغيث وغير ذلك تعظيمًا لما عظّمه الله من الأحوال.. وهكذا، وكل ذلك داخل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32].
ثالثًا: أن هناك فارقًا أيضًا ما بين اعتقاد كون الشيء سببًا واعتقاده خالقًا ومؤثرًا بنفسه، تمامًا كما مثلنا في الأصل الأول من اعتقاد المسلم أن المسيح عليه السلام سبب في الخلق بإذن الله في مقابلة اعتقاد النصراني أنه يفعل ذلك بنفسه، فإذا رأينا مسلمًا يطلب أو يسأل أو يستعين أو يرجو نفعًا أو ضرًّا من غير الله فإنه يجب علينا قطعًا أن نحمل ما يصدر منه على ابتغاء السببية لا على اعتقاد التأثير والخلق؛ لما نعلمه من اعتقاد كل مسلم أن النفع والضر الذاتيَين إنما هما بيد الله وحده، وأن هناك من المخلوقات ما ينفع أو يضر بإذن الله، ويبقى الكلام بعد ذلك في صحة كون هذا المخلوق أو ذاك سببًا من عدمه.
متى يوصف التوسل بأنه شرك؟
تقول الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، إن الشرك فهو صَرف شيء من العبادة لغير الله على الوجه الذي لا ينبغي إلا لله تعالى، حتى ولو كان ذلك بغرض التقرب إلى الله كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3]، وإنما قلنا: على الوجه الذي لا ينبغي إلا لله تعالى لإخراج كل ما خالف العبادة في مسمّاها وإن وافقها في ظاهر اسمها؛ فالدعاء قد يكون عبادة للمَدعُوّ ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ [النساء: 117]، وقد لا يكون ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: 63]، والسؤال قد يكون عبادة للمسؤول ﴿وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: 32]، وقد لا يكون ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 25]، والاستعانة قد تكون عبادة للمستعان به ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، وقد لا تكون ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: 45]، والاستغاثة قد تكون عبادة للمستغاث به ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: 9]، وقد لا تكون ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ [القصص: 15]، والحب قد يكون عبادة للمحبوب وقد لا يكون، كما جمع النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ذلك في قوله: «أَحِبُّوا اللهَ لما يَغذُوكُم مِن نِعَمِهِ، وأَحِبُّونِي بحُبِّ اللهِ، وأَحِبُّوا أَهلَ بَيتِي بحُبِّي» رواه الترمذي وصححه الحاكم. وهكذا، أي أن الشرك إنما يكون في التعظيم الذي هو كتعظيم الله تعالى كما قال عز وجل: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 22]، وكما قال سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: 165].
وبذلك يتبين فصل ما بين الوسيلة والشرك؛ فالوسيلة نعظم فيها ما عظمه الله، أي أنها تعظيم بالله، والتعظيم بالله تعظيم لله تعالى، أما الشرك فهو تعظيم مع الله، أو تعظيم من دون الله؛ ولذلك كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام إيمانًا وتوحيدًا وكان سجود المشركين للأصنام كفرًا وشركًا مع كون المسجود له في الحالتين مخلوقًا، لكن لما كان سجود الملائكة لآدم عليه السلام تعظيمًا لما عظمه الله كما أمر الله كان وسيلة مشروعة يستحق فاعلها الثواب، ولما كان سجود المشركين للأصنام تعظيمًا كتعظيم الله كان شركًا مذمومًا يستحق فاعله العقاب.
وعلى هذا الأصل في الفرق بين الوسيلة والشرك بنى جماعةٌ من أهل العلم قولَهم بجواز الحلف بما هو معظم في الشرع؛ كالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، والإسلام، والكعبة، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد قوليه؛ حيث أجاز الحلف بالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم معلّلًا ذلك بأنه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به؛ وذلك لأنه لا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى، بل تعظيمه بتعظيم الله له، وحمل هؤلاء أحاديث النهي عن الحلف بغير الله على ما كان من ذلك متضمنًا للمضاهاة بالله، بينما يرى جمهور العلماء المنع من ذلك أخذًا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله.
ونبهت: إذا ما حصل بعد ذلك خلاف في بعض أنواع الوسيلة؛ كالتوسل بالصالحين والدعاء عند قبورهم مثلًا، أو حصل خطأ فيها من بعض المسلمين فيما لم يشرع كونه وسيلة؛ كالسجود للقبر أو الطواف به فإنه لا يجوز أن ننقل هذا الخطأ أو ذلك الخلاف من دائرة الوسيلة إلى دائرة الكفر والشرك؛ لأننا نكون بذلك قد خلطنا بين الأمور وجعلنا التعظيم بالله كالتعظيم مع الله، والله تعالى يقول: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 35-36].
شد الرحال لمساجد الأولياء
بدوره، قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن آل بيت الرسول صلى عليه وسلم، لهم مكانة كبيرة لدينا، وقرر الإسلام أن نصلي ونسلم عليهم في كل صلاة بكل تشهد، ومن لم يقل فيه "وعلى آل سيدنا محمد" في الصلاة فصلاته ناقصة".
وتابع هاشم خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش على قناة الحياة، أن الصلاة صحيحة في المساجد التي بها أضرحة وزيارة أماكن الصالحين أمر مطلوب والقرآن كرم آل بيت النبي، وقبر الرسول والصحابة والتابعين في المسجد النبوي، مشيرًا إلى أن الرحال تُشد للمسجد الحرام والنبوي والأقصى بسبب فضل الصلاة فيهم، وليس حرامًا شد الرحال لزيارة الصالحين وزيارة الموتى وزيارة القبور.
وأشار أحمد عمر هاشم إلى أن فضل الصلاة في المسجد الحرام تعادل 100 ألف صلاة، والمسجد النبوي بـ1000 والأقصى بـ 500 صلاة، لهذا تُشد الرحال إليهم، مؤكدًا أنه لا يجوز أن نطلب الدعاء من ولي وإنما من الله لأنه لا وسيط بين الله والإنسان، قائلا "الذي يُطلب منه ويُسئل هو الله سبحانه وتعالى".