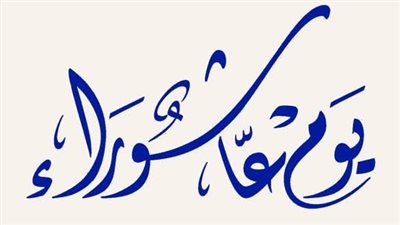مخطوطات نادرة تكشف: الحسين أراد الرجوع وأصحابه أصرّوا على المضي نحو كربلاء

لم يكن خروج الإمام الحسين بن علي نحو الكوفة مسيرًا من أجل الموت، كما قد يتبادر إلى الذهن عند استحضار المشهد التراجيدي في كربلاء,بل كان قرارًا تراكميًا، اجتمعت فيه نداءات البيعة من أهل الكوفة، وتكليفاته السياسية والروحية، إلى جانب تقدير اللحظة التاريخية التي فرضت عليه أن يكون في الطليعة، بين خيارين: إمّا المضيّ نحو العراق أو القبول بالبيعة ليزيد، وهو ما كان الحسين يرى فيه مصادرة للحق، وانهيارًا للعدالة.
مخطوطات تاريخية تكشف.. كيف كان الطريق لكربلاء؟
يقول الباحث مصطفى زايد أن كثيرًا من المخطوطات التاريخية الموثوقة تكشف عن مرحلة حرجة وسط الطريق، بين مكة والكوفة، حين بلغ الحسين نبأ خذلان أهل العراق، ومقتل ابن عمه وسفيره مسلم بن عقيل، فأوقف الركب في منطقة تُدعى "ذو حسم"، ووجّه حديثه إلى من معه، في لحظة صدق واستشارة. قال، كما روى ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم والملوك (ج٤، ص٣٠٤): "قد خذلنا شيعتنا، فمن أحبّ الانصراف فلينصرف، ليس عليه منّا ذمام". كلمات واضحة، خالية من التورية، تعني أن الإمام كان لا يزال يرى الباب مفتوحًا للرجوع، وأن من أراد السلامة فله ذلك دون حرج.
لكن المفاجأة لم تكن في قراره، بل في ردّ الفعل. لم يتزحزح أحد، بل تقدم بنو هاشم وأبناء مسلم بن عقيل، وأقسموا: "والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر ابن عمنا أو نذوق ما ذاق". هذا ما سجله أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين (ص٨٩)، وهو نص يكشف عن روح الثأر النبيل، الذي لم يكن انتقامًا دمويًا، بل وفاءً لمعنى الشهادة والبيعة والمروءة.
الحسين رأى أن جميع من حوله شركاء في الحكم
أضاف “زايد”يبدو أن هذا الموقف الجماعي هو ما أعاد تشكيل القرار, فالحسين لم يكن قائدًا مغلقًا على ذاته، بل كان يرى في من حوله شركاء في الحُكم والمصير, وفي كتاب اللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس (ص٥٦)، نُقل أن زهير بن القين – أحد فرسان الركب – قام وحذّر الحسين من التراجع، قائلاً إن الرجوع الآن سيمنح يزيد نصرًا معنويًا، وسيُفهم على أنه خوف أو تردد، وسيتحوّل إلى أداة طعن في سيرة الحسين نفسه، بل وخذلان لدم مسلم بن عقيل.
محادثة مطوّلة بين الحسين وأخيه
أضاف الباحث الصوفي:وفي واحدة من أهم الحوارات التي وردت في كتاب الفتوح لأحمد بن أعثم الكوفي (ج٥، ص٩٥)، نقرأ محادثة مطوّلة بين الحسين وأخيه محمد بن الحنفية قبل الخروج من مكة، يظهر فيها بجلاء وعي الحسين الكامل بخطورة الذهاب إلى العراق. بل كان محمد يحثّه على التمهّل، فكان جواب الحسين: "شاء الله أن يراني قتيلًا، وشاء أن يراهنّ سبايا". هذه العبارة، التي كثيرًا ما تُتلى في مجالس العزاء، لم تكن تعبيرًا عن استسلام، وإنما إشارة إلى وعي الحسين بالقَدَر الذي ينتظره، دون أن يعني ذلك أنه قرر الموت بملء إرادته.
فبين الرغبة في الرجوع، وموقف أصحابه، وبين التقدير العميق لمعاني الشهادة والواجب، تحركت الكفة نحو كربلاء، لا باعتبارها محطة انتحار، وإنما باعتبارها لحظة تجلٍّ كبرى للثبات على الحق، مهما كان الثمن.
ولفت “زايد” إلى أن من المهم في هذا السياق أن نعيد قراءة النصوص التاريخية بعيدًا عن الحمولات العاطفية التي شحنتها الروايات الشعبية، فقد تم تضخيم كثير من المرويات التي صوّرت الحسين كمن خرج منذ البداية من أجل الموت فحسب. لكن التوثيق الدقيق للمصادر الأصلية يكشف عن رجل دولة، وقائدٍ نبيليّ، خاض لحظة تردّد أخلاقي صادق، ونزاع داخلي مشروع، ثم مضى لأنه رأى أن دوره لا يكتمل بالرجوع، بل بالبقاء مع أصحابه، وتحقيق الكلمة الأخيرة في وجه سلطان الجور.
المشاركة في القرار
وما يؤكده الطبري وغيره من مؤرخي تلك المرحلة أن أصحابه لم يكونوا تابعين عميانًا، بل كانوا أصحاب قرار، وتقدير، ومشاركة وجدانية. قال الحسين لهم: "فمن أراد الانصراف فلينصرف"، لكنه لم يجد منهم إلا الحماسة للمضي، حتى من كبار شيوخ القوم، ممن لم تكن في أعمارهم بقية طويلة، لكنهم رأوا في تلك الرحلة آخر ما يقدموه وفاءً لرسالة جدّه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
كيف أدار الحسين مشهد كربلاء
وأوضح “زايد”أن الحسين أدارمشهد كربلاء لا كقديس صوفي ذاهب إلى الفناء، بل كإمام يدرك أن القيادة لا تعني الإصرار، بل القدرة على المراجعة، ثم الرجوع عن الرجوع عندما تنبعث الإرادة من بين يدي الصحابة الذين أبَوا أن يتركوه وحده، ولا أن يعودوا من دونه، ولا أن يحتموا بالحياة بينما سيدهم مهدّد بالموت.
ولعل هذا هو الدرس الخفي في هذه المرحلة من سيرة كربلاء: أن القائد الحقيقي ليس من يتمسك برأيه حتى النهاية، بل من يصغي، ويتفاعل، ويتخذ قراره الجماعي من خلال محبة أتباعه وثقتهم به، ليكون قائدًا بمعنى الأخوّة لا التسلّط.
وإذا كان الحسين قد اختار أن يمضي إلى النهاية، فقد اختار أن يكون معهم، لا فوقهم، وأن يستشهد بينهم، لا أمامهم. ولو أنه رجع، وكانوا هم من تخلّفوا، لما قامت ثورة كربلاء في الوجدان الإنساني، كما قامت اليوم. فاستمرار المسير لم يكن قدرًا مفروضًا، بل فعلًا حرًا مشتركًا، قاده الحسين، وأصرّ عليه أصحابه، ليُكتب على الأرض دم لا يزول، واسم لا يُنسى.