الفلسفة في الذكاء الاصطناعي من التنظير إلى الممارسة الإبيستيمولوجية؟
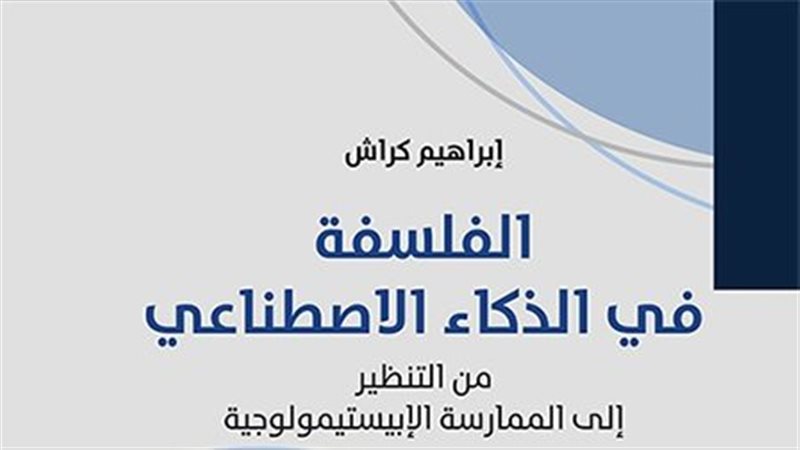
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب الفلسفة في الذكاء الاصطناعي: من التنظير إلى الممارسة الإبيستيمولوجية، وهو من تأليف إبراهيم كراش، ويقع في 257 صفحة، متضمّنًا ملخّصًا تنفيذيًّا، ومقدمة، وأربعة فصول، إضافة إلى خاتمة، ومراجع، وفهرس عام.
يهدف الكتاب إلى استكشاف العلاقة العميقة بين الذكاء الاصطناعي والفلسفة من خلال تحليل أسس الذكاء الاصطناعي الإبيستيمولوجية والفكرية، وإبراز كيفية تحوله، بوصفه مجالًا علميًّا وتقنيًّا، إلى موضوع تأمّل فلسفي بالغ الأهمية.
ويشير الكتاب إلى أن الذكاء الاصطناعي ينمو ضمن منظومة معرفية وتقنية معقّدة يمكن اختزالها بكلمة "لوغوس". ويسعى إلى تفكيك الخلفيات الفلسفية لهذا المشروع، من خلال عرض نقدي لمواقف فكرية قدّمها جون سيرل وهوبرت دريفوس، وإلى تسليط الضوء على مرجعيّتين فلسفيتين أساسيتين؛ هما: التقليد التمثّلي (العقلاني والتجريبي) والنزعة الوظيفية.
من ميكنة الفكر إلى فلسفة الآلة
يتناول كتاب الفلسفة في الذكاء الاصطناعي تطور فكرة الذكاء الاصطناعي من جذورها الفلسفية إلى تكوّنها العلمي المعاصر، مشدّدًا على صِلتها الوثيقة بالفكر الإبيستيمولوجي، فمنذ العصور الوسطى، عبّر الفلاسفة عن رغبتهم في ميكنة الفكر، منهم: ريموند لول الذي صمّم آلة رمزية، وبليز باسكال الذي صنع آلة ميكانيكية للحساب. أمّا رينيه ديكارت فقد رفض فكرة أن تكون الآلات قادرة على التفكير، بحجّة أن الوعي واللغة يتجاوزان حدود الميكانيكا. في المقابل، رأى جوتفريد ليبنتز أن الفكر قابل للتمثيل الرمزي.
ومع تطوّر المنطق الرمزي وابتكار آلة تورينغ، تأسَّس علم الحوسبة وبدأ الذكاء الاصطناعي يُطرح مجالًا يهدف إلى محاكاة قدرات بشرية كالرؤية واللغة والاستدلال، إلا أنّنا ما زلنا بعيدين عن تحقيق ذكاء مماثل للبشر. فإشكالية تعريف الذكاء – سواء البشري أو الاصطناعي – لا تزال عالقة؛ إذ يُنظر إلى الذكاء بوصفه خاصيةً إنسانيةً ترتبط بالإدراك والتعلم وحلّ المشكلات، في حين يسعى الذكاء الاصطناعي إلى نمذجة هذه العمليات، رغم محدودية فهمنا للفكر والدماغ.
تشعّب المفاهيم والنقد الفلسفي
تتنوع تعريفات الذكاء الاصطناعي باختلاف الخلفيات المعرفية: فثمّة باحثون يركّزون على تمثيل المعرفة، وآخرون يركّزون على المحاكاة البيولوجية، أو على معالجة الرموز، أو حتى أداء المهمّات الشبيهة بالبشر. غير أن هذا المجال لا يُعد علمًا موحّدًا، بل هو ميدان متعدد التخصص يجمع بين المعلوماتية والفلسفة واللغويات وعلم النفس وعلوم الأعصاب. ويرى باحثون مثل دانييل أندلر أن الذكاء الاصطناعي ما زال حقلًا غير مكتمل التكوين العلمي.
ويفتح هذا التداخل المعرفي أمام الفلسفة أبوابًا جديدة للتفكير، ويدفعها إلى إعادة النظر في مفاهيمها التقليدية مثل الفهم والإرادة الحرة والقصد. وقد ساهم الذكاء الاصطناعي في إعادة صوغ أسئلة فلسفية كلاسيكية، مثل حدود العقل، وطبيعة الإدراك، ومعنى أن نفكّر. ومع ذلك، فإن ثمّة فلاسفة توجّهوا إلى نقد هذا المجال، مشيرين إلى عجزه عن تمثيل الفهم الحقيقي، وإلى انفصال الآلة عن الجسد والعالم، وهو ما يُضعف قدرتها على محاكاة السلوك الذكي.
الذكاء الاصطناعي بين الأسطورة والعقل
يوضح هذا الكتاب أن الذكاء الاصطناعي ليس نتاجًا علميًّا محضًا، بل هو استمرار لمسار ثقافي وفكري طويل، تُمزج فيه الأسطورة بالعقل، ويتغذّى من روافد فلسفية ولسانية وعصبية. فلطالما حلم الإنسان بكائنات ذكية، وظل هذا الحلم يتردّد في الأساطير، قبل أن يتحوّل تدرّجًا إلى خطاب عقلاني – لوغوس – قائم على التجريب والنمذجة. في هذا السياق، يناقش الكتاب مسألة ما إذا كان من الممكن محاكاة الفكر آليًّا، ويسائل مدى قدرة الحواسيب على تمثيل التفكير الرمزي. فهو يرى أن الذكاء الاصطناعي، على غرار مساعي الفلاسفة ما قبل سقراط، يبتعد عن الأسطورة ويسعى إلى تأسيس خطاب عقلاني جديد.
يتتبع المؤلف هذا المسار في أربعة فصول؛ يحدد الفصل الأول مشروع الذكاء الاصطناعي عبر نصوص تأسيسية، كنص تورينغ وندوة دارتموث، مقترحًا تعريفًا مزدوجًا له: من جهة الآلات والخوارزميات الذكية، ومن جهة الأمل بأن تحل هذه الآلات محل الجهد البشري.
أما الفصل الثاني، فيتناول أسطورة الذكاء الاصطناعي بوصفها بقايا ثقافية سابقة على العلم، كانت تهدف إلى خلق كائنات مشابهة للإنسان، ثم يوضح كيفية تراجع هذه الأسطورة لمصلحة اللوغوس المؤسس على النماذج الرياضية والمنطقية.
ويربط الفصل الثالث الذكاء الاصطناعي بالتقليد التمثّلي والنزعة الوظيفية، باعتبارهما يريان في الفكر نظامًا رمزيًّا قابلًا للتحليل والبرمجة، ويشير إلى إمكانية إنتاج الفهم العقلاني برمجيًّا إذا اعتُبِرَت عملياته وظائف مستقلة عن مادتها العضوية.
ويستعرض الفصل الرابع انتقادات دريفوس وسيرل التي تبرز محدوديات الذكاء الاصطناعي؛ وهي: غياب الفهم الحقيقي، وعجز القواعد الصورية عن تفسير السلوك الذكي، وانفصال الحاسوب عن الجسد والعالم.
في خاتمة كتاب الفلسفة في الذكاء الاصطناعي: من التنظير إلى الممارسة الإبيستيمولوجية، يؤكّد المؤلِّف أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرّد موضوع تأمل فلسفي، بل هو فلسفي في جوهره. إنه يوقظ الأسئلة الكبرى حول الفكر والعقلانية والدلالة، ويستدعي مقاربات إبيستيمولوجية جديدة، فالعلاقة بين الفلسفة والذكاء الاصطناعي ليست علاقة خارجية، بل هي تماهٍ في سؤال الوعي ذاته، وفي البحث عن كيفية إعادة تفسيره عبر الآلة.







