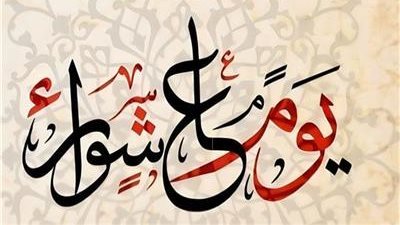بين السر والعلانية.. ما هي مظاهر الاحتفاء الصوفي بـ عاشوراء؟

يوم عاشوراء.. في قلب التقويم الروحي لأهل التصوف، لا تمر الأيام كما تمر على الناس، بل تتلبس معانيها، وتفيض بأسرارها، وتُقرأ بوصفها رموزًا وتعيينات للمقامات الباطنية.
ويوم عاشوراء، العاشر من محرم، لا يُعدّ عندهم يوماً عاديًّا من أيام الصيام المشروع فحسب، بل هو زمنٌ مضغوط بالمعنى، تفتح فيه أبواب الغيب، وتتقاطع فيه سُبل الأنبياء والأولياء، وتجتمع فيه محطات الفقد والخلاص في حضرة الذكر والتجلي.
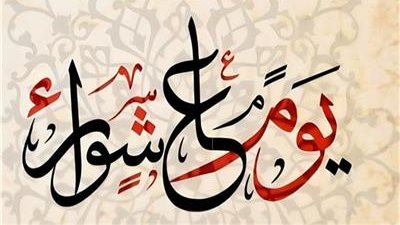
عاشوراء في حضرة الذكر الصوفي: حي
يرى الصوفية في هذا اليوم "وقفة روحية كونية"، تتداخل فيها الأزمنة: زمن نجاة موسى من فرعون، وزمن استشهاد الحسين في كربلاء، وزمن تطهير النفوس بالصيام والذكر، وزمن التجلي المحمدي في رحمته الممتدة إلى من تبعه من أهل الحقيقة. هو ليس يوماً واحدًا، بل طبقات من المعنى، تُستخرج بالرؤية القلبية، لا بالنظر الظاهري وحده.
الجذور الشرعية والوجدانية ليوم عاشوراء في التصوف
ينطلق الصوفية في تعاملهم مع هذا اليوم من أصول راسخة في السنة النبوية، حيث حثّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم على صيامه، لما فيه من شكر لله تعالى على نجاة نبي من أولي العزم، هو موسى عليه السلام، من قبضة الطغيان. لكنهم لا يكتفون بهذا الظاهر، بل يغوصون إلى العمق: فما نَجَاة موسى إلا تجلٍّ للمقام السابع في السير، حيث يقطع السالك البحر، أي النفس، ويتجاوز فرعونها، أي الهوى، ويبلغ برّ الأمان بالثقة المطلقة في "كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ".
ويمتد التفاعل مع عاشوراء إلى مقامات الألم والافتداء، حيث يُستحضر مشهد الحسين بن علي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قُتل ظمآنًا تحت شمس كربلاء. وهنا لا يتعامل الصوفي مع الحدث من باب الحزن السياسي أو الرؤية المذهبية، بل من باب الفناء في المحبة، حيث يصير الحسين رمزًا للتجرد الكامل من الدنيا في سبيل الله، وللثبات على الحق في وجه الجبروت، وللذوبان في الإرادة الإلهية. لذلك، لا يُحزن الصوفي على الحسين كما يُحزن الناس، بل يحزن على نفسه أن لم يَفْنَ كما فنى.
الزوايا الصوفية لا تحتفي بيوم عاشوراء كمجرد مناسبة طقوسية، بل تعيشه كحالة كونية تعبر عنها بمزيج من الذكر، والتوسعة، والحنين إلى مقامات الأنبياء وأرواح الشهداء.
في الذكر تتسع الروح: في ليلة عاشوراء، تُقام حلقات الذكر الكبرى في الزوايا، خاصة القادرية والرفاعية والتيجانية، حيث يُرتل الورد الخاص لكل طريقة، وتُشدّ الأوتار القلبية بالاسم الأعظم، ويُسبّح الجمع بالتسبيحات الخفية التي لا تُسمع إلا بآذان القلوب. الذكر في عاشوراء ليس تكرارًا للحروف، بل خَفَقٌ في القلب، وشوقٌ للمقام.
الإنشاد النوراني: تنطلق الحناجر في حضرات عاشوراء بقصائد في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقصص نجاة موسى، وأشعار الحلاج وابن الفارض التي تذيب الحدود بين الفقد والنور. الإنشاد هنا ليس فنيًا، بل كشفٌ روحي يُفتَح على المريدين بحسب حالهم.
الختمات القرآنية الجماعية: في بعض الزوايا، وخاصة الزاوية الشاذلية، تُقام ختمات قرآنية يُهدى ثوابها لأرواح الشهداء، ولأرواح الأولياء، ويتلى فيها سورة يونس وسورة القصص، لما فيهما من تجليات قصة موسى، وشرح لصراع الحق والباطل.
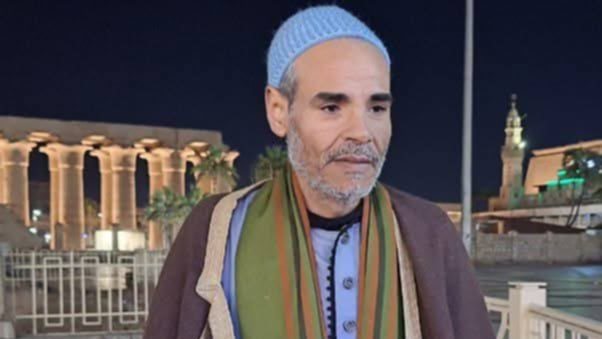
الزردة: طعام الأرواح والبطون
لا تغيب المائدة في هذا اليوم، ولكنها ليست مائدة للطعام وحده، بل مائدة للكرم الباطني. في الطرق المغاربية، كالبودشيشية والتيجانية، تُقام "الزردة"، وهي وليمة جماعية تُطبخ فيها أطباق خاصة، ويُوزع فيها الطعام للفقراء والمحبين، على نية البركة، والتوسعة، واستنزال الرحمة.
أما في الطرق المصرية، فتُوزّع الحلوى التقليدية، وتُقام ولائم في الزوايا، ويُكتب على بعضها أسماء الأولياء، تبركًا بهم. بعض المشايخ يُحبّذ أن يكون الطعام "حلواً"، رمزًا للفرح بالله رغم الأحزان، وبعضهم يحب أن يكون فيه "ملح" رمزًا لصبر موسى، و"تمر" رمزًا لثبات الحسين.
الدروس والمواعظ: الكلام يُصبح شفاءً
يقول مصطفى زايد الباحث في الشأن الصوفي: يُخصّص المشايخ الدروس في هذا اليوم لشرح معاني النجاة والابتلاء، فيُقرأ من سيرة موسى، وسيرة الحسين، وسيرة الأولياء الذين فَنَوا في حب الله. ويُعاد على مسامع المريدين ما قاله الجنيد عن الصبر، وما قاله البسطامي عن التسليم، وما قاله الإمام علي عن مرارة الحق وحلاوته.
يُركّز بعض المشايخ على تعليم المريدين أن عاشوراء ليس "يوماً شيعياً" كما يقول البعض، ولا "يوم فرح" كما قد يُبالغ آخرون، بل هو يوم "تمازج النور والدمع"، فيه ترى كيف يكون الحزن سلماً إلى الرضا، والدمع وسيلة إلى الذكر.
الطرق الصوفية في عاشوراء: اختلاف في الشكل واتحاد في المعنى
في الطريقة القادرية، يُعاد تلاوة أوراد عبد القادر الجيلاني، ويُقرأ في "الغنية لطالبي الحق"، وتُتلى قصائده في الصبر والفناء.
في الزوايا الرفاعية، تُضاء الشموع رمزًا للنور في وجه الظلم، وتُقرع الدفوف، ويُرفع "الحجّاب" في بعض الزوايا كعلامة على فتح باب التوبة.
في الطرق المغاربية، تتلألأ "الزردات" وتُعلّق رايات بيضاء، وتُقرأ قصائد البردة والهمزية، وتُختم الحضرة بدعاء جماعي يُقرأ فيه دعاء موسى على فرعون، ودعاء الحسين في كربلاء.
الأبعاد الباطنية لعاشوراء: تطهير، تجديد، وتوسعة
يعتقد الصوفي أن هذا اليوم باب، وأن كل باب لا يُطرَق في وقته يُغلق إلى حين. فهو باب للتطهير من الذنوب، بالصيام، وبالذكر، وبالدموع. وهو باب للتجديد، لأن كل سنة هجرية تبدأ بالمحرّم، وعاشوراء نقطة الوعي في هذا الابتداء. وهو باب للتوسعة، لا بالمال فقط، بل بالمحبة، بالدعاء، بالتآلف، بالكلمة الطيبة.
عاشوراء.. مرآة السالك في الطريق
ليس يوم عاشوراء لحظة عابرة في رزنامة التصوف، بل مقام يزوره القلب كل عام، فيقف فيه بين موسى والحسين، بين النجاة والدم، بين البحر والصحراء، بين العبور والاستشهاد، ويُسأل: أي الطريق تسلك؟
إنها مناسبة للذكرى، لا بالعقل فقط، بل بالقلب. مناسبة للتوسعة، لا بالبطن فقط، بل بالروح. مناسبة للبكاء، لا حزنًا على الماضي، بل شوقًا للمقامات التي بلغها الأنبياء والأولياء.