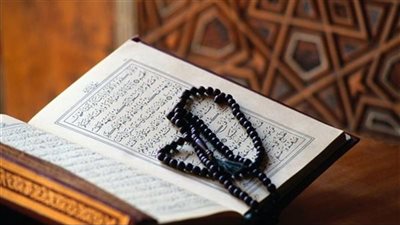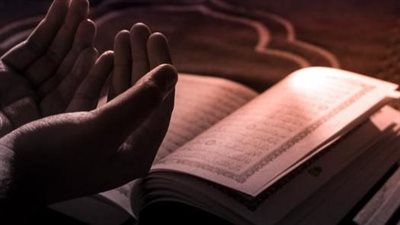الرعب أم الرحمة: هل تربينا على عبادة إله لا يعرف الحب؟.. أزهري يرد|خاص

قال الدكتور عبدالحميد متولي، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشؤون الإسلامية بأمريكا اللاتينية والكاريبي، ورئيس الجامعة الإسلامية بالبرازيل، ردا على حديث أن التراث الإسلامي جعل من الإله مصدر للرعب وأن لقائه في الآخرة هو مذبح.
حيث يقول المفكر عادل نعمان إننا ورثنا صورة مشوَّهة عن الله: إله يُراقب ويحاسب لا إله يحب ويرحم. تربّت أجيال على عبادة الرعب لا الرحمة، فصار لقاء الله «مذبحًا» لا «موعدًا مع النور».. آن الأوان لاستعادة معنى الإيمان القائم على الحب لا الخوف.
وقال «متولي» في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»: هذه العبارة تمسّ جوهر العلاقة بين الإنسان وربّه، وتطرح سؤالًا عميقًا: هل تربّينا على عبادة الخوف لا الحب؟، والحقّ أن من الإنصاف أن نُفرّق بين الدين في نصوصه والتدين في ممارساته؛ فالوحي الإلهي لم يقدم يومًا «إله الرعب»، بل «إله الرحمة والعدل»، أما ما يظهر من إفراطٍ في خطاب التهديد والعقوبة فذلك نتاجُ اجتهادات بشرية غير متوازنة، لا مرجعية شرعية لها.
الله في الوحي: رحمةٌ تسبق الغضب
وأوضح: يفتتح القرآن العظيم مئةً وثلاث عشرة سورة بالبسملة، ليغرس في الوجدان أن الله تعالى رحمن رحيم قبل أن يكون جبارًا منتقمًا. قال تعالى:﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف: 156)، ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ (الأنعام: 54)
وفي الحديث القدسي الصحيح: «إنَّ رحمتي سبقت غضبي» (رواه البخاري ومسلم). فهذه النصوص ليست مجرد تذكير، بل تأسيس لعقيدةٍ رحيمة ترى في الله تعالى المربّي الرؤوف قبل المحاسب العادل، وتجعل الخوف وسيلة للتقويم لا غايةً للرعب.
التوازن بين الخوف والرجاء
العبادة في التصور الإسلامي لا تقوم على طرفٍ دون الآخر، بل على التوازن بين المحبة والخوف والرجاء.
قال الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين: «العبد في سيره إلى الله كطائرٍ رأسُه المحبة، وجناحاه الخوف والرجاء، فمتى فُقد أحد الجناحين هلك الطائر»، وقال ابن القيم في مدارج السالكين: «القلب في سيره إلى الله لا يصلح إلا بثلاثة أركان: محبةٍ تُحرّك، وخوفٍ يزجر، ورجاءٍ يبعث على العمل»، إذن فـ«الخوف» في الإسلام ليس رعبًا يشلّ القلب، بل خشيةٌ إيجابيةٌ تردع عن المعصية، و«الرحمة» ليست تساهلًا يُسقط العدالة، بل حبٌّ يفتح باب الرجاء
جذور الخلل في الخطاب الديني
وبين أن المشكلة ليست في النصوص، وإنما في طريقة عرضها وتوظيفها، فحين يتحول الدين إلى خطابٍ سلطويٍّ أو تهويليٍّ يركّز على العقاب دون التعريف بجمال صفات الله، تتشوّه الصورة ويضعف الأثر التربوي.
وقد أشار عدد من المفكرين إلى أن الخطاب الديني في بعض مراحله التاريخية طغت عليه لغة الوعيد والتهديد، حتى غاب عنه بعدُ الحبّ والرجاء، الذي هو روح العبادة وسرّ الإيمان.
ولذلك فإن العلاج لا يكون بالتقليل من شأن الخوف، بل بردّ التوازن إليه؛ نُربي أبناءنا على أن الله يُحبّ عباده، ويغفر زلاتهم، ولكنه أيضًا لا يحبّ الظلم ولا يرضى بالفساد.
الإسلام دين المحبة المسؤولة
قال الله تعالى في وصف عباده: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ (السجدة: 16)، فجمع بين الخوف والطمع، لأن الإيمان الحقّ لا يقوم على أحدهما دون الآخر، مشيرًا إلى أن عبادة الخوف بلا محبة قسوة تُبعد، وعبادة الحب بلا خشية تهاون يُضل.
أما الإسلام، فقد علمنا أن المحبّة الصادقة تولد الطاعة، والخشية الصادقة تمنع الغفلة، والرجاء الصادق يبعث على العمل.
نداء إلى الدعاة والمربين
وشدد على أن مسؤولية العلماء والدعاة اليوم أن يصحّحوا صورة الإله في وجدان الناس؛ أن يُحدّثوا الناس عن ربٍّ قريبٍ ودودٍ، يسمع دعاءهم، ويحب توبتهم، ويبدل سيئاتهم حسنات.
قال تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ العَذَابُ الأَلِيمُ﴾ (الحجر: 49–50)، فهكذا يجمع القرآن بين الترغيب والترهيب، بين الجمال والجلال، ليظلّ المؤمن في عبادةٍ متّزنة، فيها الحبّ والخوف، والرجاء والعمل.
واختتم بالقول، إن القول بأننا «نعبد إله الرعب لا الرحمة» تعميم لا يليق بجوهر الإسلام، وإن كان يشير إلى ممارسات تحتاج مراجعة، فالإسلام في نصوصه ومقاصده دين الرحمة والطمأنينة، ودينُ الخشية الواعية أيضًا.
من عرف الله بأسمائه الحسنى أحبه، ومن أحبّه أطاعه، ومن أطاعه وجد في عبادته أنسًا لا رعبًا، فلنُربِّ أبناءنا على الإيمان المتوازن، الذي يرى في الله ملاذًا وملجأً، لا سوطًا ولا رعبًا، وعلى أن الطريق إليه محفوف بالمحبة، محروس بالخوف، منير برجاء رحمته.