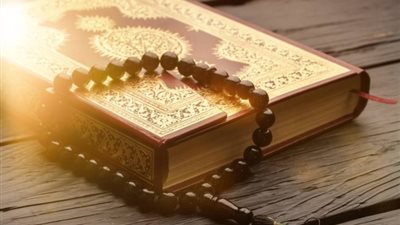هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفطر ومتى تسقط؟.. دار الإفتاء تجيب

يقترب شهر شوال ويكثر معه البحث عن زكاة الفطر وأحكامها وهل تسقط عن المديون، وفي السطور التالية نوضح ما ذكرته دار الإفتاء المصرية.
حكم زكاة الفطر لمن عليه دين
يقول السائل: هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟، لتوضح دار الإفتاء أن زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ولا يمنع الدَّيْنُ من وجوبِها على المكلف ما دام أنَّه يمتلك ما يزيد عن قُوتِه وقُوتِ عياله ممن تجب عليه نفقتهم يومَ العيد وليلتَه.
وبينت أن زكاة الفطر: هي مقدار مُتَقَوَّم من المال يَجِبُ على المسلم بشروط مخصوصة؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين.
ومقدار الصاع: 2.040 كجم على مذهب الجمهور؛ فقد جاء في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية أخرى: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه البخاري.
وقد نقل الإجماعَ على وجوبها غيرُ واحد من الأئمة؛ كالإمام ابن المُنذِر في "الإشراف"، والإمام ابن قُدَامة في "المغني"، والحافظ وليُّ الدين أبو زُرْعَة العراقي في "طرح التثريب".
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
ولفتت إلى أن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر هي التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في يوم العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدَّارَقُطْنِي في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه ابن وهب في "جامعه"، وابن زَنْجَوَيْه في "الأموال"، والبَيْهَقي في "السنن الكبرى".
حكم زكاة الفطر لمن عليه دين
وأكدت أن من شرائط وجوب زكاة الفطر: الغِنَى واليَسار، وضابطه أن يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، من غير اشتراطٍ للنِّصَاب كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. يُنظر: "الإقناع" للعلامة ابن القَطَّان، و"المجموع" للإمام النووي، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة.
أما الحنفية: فيشترطون أن يكون مالكًا للنِّصَاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مالٍ كان، سواء كان النِّصَاب ناميًا أو غير نامٍ، ولم يشترطوا بقاء النِّصَاب حولًا كاملًا؛ فمن كان عنده هذا القدر فاضلًا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تلزمه نفقته من مأكل وملبس ومسكن ونحوها، وجبت عليه زكاة الفطر، وإلا فلا تجب عليه.
وإن كان عليه دَيْن وهو محل السؤال، فقد اختلف الفقهاء في وجوبها عليه حينئذ، فذهب الحنفية إلى أن الدَّيْن لا يمنع وجوبها إذا لم يكن له مُطالِب من جهة العباد؛ كدَيْنِ النذر والكفارات حال كون المكلف بها مالكًا النِّصَاب، فإن كان له مُطالِب من جهة العباد، سواء كان لله كالزكاة، أو للعباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلفات وغيرها فإنه يمنع وجوبها إذا كان مستغرقًا للنِّصَاب أو كان ما زاد عن قدر الدَّيْن لا يبلغ نِصَابًا وإن لم يستغرقه بأن كان معه نِصَاب زائد عن قدر الدَّيْن فلا يمنع وجوبها.
وقال الشافعي: تجب لتحقق السبب وهو ملكُ نِصَابٍ تامٍّ) فإن المديون مالك لماله لأن دَيْن الحر الصحيح يجب في ذمته، ولا تعلُّق له بماله، ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء (ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية) أي مُعَدٌّ لما يدفع الهلاك حقيقةً أو تقديرًا لأن صاحبه يحتاج إليه لأجل قضاء الدَّيْن دفعًا للحبس والملازمة عن نفسه، وكل ما هو كذلك اعتُبر معدومًا كالماء المستحق بالعطش لنفسه أو دابته] اهـ.
وذهب المالكية إلى أن الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة، بل إنه إذا كان مستغرِقًا لِقُوتِه وقُوتِ عياله؛ فإنه يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو وفاء هذا القرض؛ لأنه قادر حكمًا، وإن كان لا يرجو الوفاء لا تجب عليه، فعُلِم أنه لا تسقط زكاة الفطر عندهم بالدَّيْن؛ لأنه إذا وجب أن يقترض لأدائها، فالدَّيْن السابق عليها أولى ألَّا يُسقِطها عنه.
وأما الحنابلة: فإنهم فرَّقوا بين الدَّيْن المؤجل والمعجَّل، فالمؤجل لا يمنع وجوب زكاة الفطر عندهم، بخلاف المعجَّل؛ قال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": [(وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وُجُوبَ الْفِطْرَةِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ مُطَالَبًا بِهِ) لِتَأَكُّدِهَا، بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا عَلَى الْفَقِيرِ] اهـ.
والمختار للفتوى أن الدَّيْن لا يمنع وجوب زكاة الفطر، ما دام المكلف بها يمتلك فائضًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته؛ لما فيها من التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغنائهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.