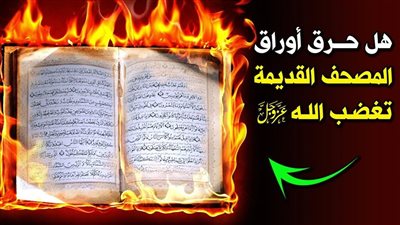ما حكم التشاؤم من الزوجة؟ دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

تواجه بعض الزوجات اتهامات ظالمة من أهل أزواجهن بكونهن سببًا في النكبات أو الحوادث أو الخسائر التي تصيب العائلة بعد الزواج. ويطلق البعض على ذلك في الثقافة الشعبية "وشها وحش"، مما يسبب أذى نفسيًا ومعنويًا شديدًا للزوجة. ومن هنا يثور سؤال يتكرر على ألسنة كثيرين: ما حكم التشاؤم من الزوجة في الإسلام؟
حكم التشاؤم في الإسلام
أكدت دار الإفتاء أن التشاؤم بالزوجة أو غيرها من الأشخاص منهيٌّ عنه شرعًا، وأنه من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام لهدمها. واستشهدت بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ»، قيل وما الفأل؟ قال: «كلمة طيبة» (متفق عليه).
وبحسب الفقهاء، فإن التشاؤم أو ما يسمى بالطيرة يعد سوء ظن بالله تعالى، وقد يكون سببًا في وقوع المكروه عقوبةً على هذا الاعتقاد الفاسد.
ما معنى «إنما الشؤم في ثلاث»؟
قد يلتبس الأمر على البعض بسبب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ» (متفق عليه). وهنا توضح دار الإفتاء أن المقصود بالحديث ليس إثبات أن هذه الأشياء تجلب النحس، بل الإشارة إلى أن الشؤم قد يكون في صفات الشخص أو الحال التي تترتب عليها فتنة أو نزاع.
وقد جاءت رواية أخرى في المستدرك للحاكم تفسر الحديث بأن السعادة والشقاء قد يرتبطان بصفات الزوجة أو الدار أو الدابة، وليس بذواتها. فالمرأة الصالحة مصدر سعادة، أما التي تسوء الزوج وتفقده الأمان فهي من الشقاء.
موقف الشرع من اتهام الزوجة بسوء الحظ
أوضحت الفتوى أن تحميل الزوجة مسؤولية الحوادث أو الأمراض أو الخسائر التي تقع للأسرة، كما يشيع في بعض المجتمعات، أمر محرم شرعًا. فالأحداث كلها تجري بأسبابها بقدرة الله تعالى، ولا دخل للزوجة فيها. والإصرار على وصم الزوجة بكونها مصدر شؤم يعد ظلمًا بيّنًا يتنافى مع قيم الإسلام في حسن الظن والستر وصيانة الكرامة.
يتضح من النصوص الشرعية أن حكم التشاؤم من الزوجة هو المنع والتحريم، وأنه لا يجوز شرعًا إلصاق النكبات أو المصائب بها. فالتشاؤم من بقايا الجاهلية التي جاء الإسلام ليقضي عليها، والمسلم مأمور بحسن الظن بالله تعالى، والإيمان بأن الخير والشر بيده وحده.