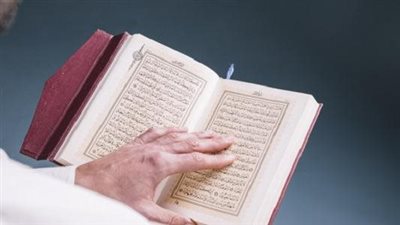ما حكم صلاة المريض الذي يحمل نجاسة في كيس؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية : على المريض في هذه الحالة أن يتوضأ لكل صلاة من غير أن يتكلف إزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث، ما دام يغلب على الظن استمرار عملية الإخراج وقت أداء الصلاة؛ لأنه من أصحاب الأعذار وقت استمرار حدثه، كما ينبغي عليه الصلاة بالهيئة التي يقل أو يرتفع بها عذره، ولو بالإيماء إن كان يحصل به ذلك.
وتسقط عنه صلاة الجماعة والجمعة، ويصلي الجمعة ظُهرًا، ويجوز له -للحاجة- أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أو يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّا.
صلاة المريض الذي يحمل نجاسة في كيس
الحكم الشرعي لمن عجز عن تحصيل الطهارة لاستمرار حدثه هو الوضوء لكل وقت صلاة مرة واحدة، ولا يلزمه شرعًا إزالة النجاسة لكل وقت، فإذا اتفق وضوءه لوقت صلاة وانقطع حدثه حتى دخل في وقت الصلاة التي تليها لم يجب عليه إعادة الوضوء ما دام قد أتم الصلاة خاليًا من الحدث.
أما إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان ونحوه فلا تجب إذا غلب على ظنه أن الموضع يتنجس مرة أخرى قبل تمام الصلاة، فإن غلب على ظنه أن الموضع يظل طاهرًا حتى يتم صلاته وجب عليه أن يزيل النجاسة؛ قال العلامة الحصكفي الحنفي في “الدر المختار”: أن صاحب العذر هو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة أو بعينه رمد أو عمش أو غرب، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرّة إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنًا يتوضأ ويصلي فيه خاليًا عن الحدث، لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم، وهذا شرط العذر في حق الابتداء، وفي حق البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت ولو مرة، وفي حق الزوال يشترط استيعاب الانقطاع تمام الوقت حقيقة، لأنه الانقطاع الكامل، وحكمه الوضوء لا غسل ثوبه ونحوه لكل فرض، ثم يصلي به فيه فرضًا ونفلًا فدخل الواجب بالأولى، فإذا خرج الوقت بطل أي ظهر حدثه السابق، حتى لو توضأ على الانقطاع ودام إلى خروجه لم يبطل بالخروج ما لم يطرأ حدث آخر أو يسيل كمسألة مسح خفه، وأفاد أنه لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر، وإن سال على ثوبه فوق الدرهم جاز له أن لا يغسله إن كان لو غسله تنجس قبل الفراغ منها، وإلا يتنجس قبل فراغه فلا يجوز ترك غسله، هو المختار للفتوى.
ويستوي في هذا الحكم أصحاب الأعذار من دماء وقيح وصديد وماء جرح وماء عين وأذن وثدي؛ قال العلامة ابن عابدين في “حاشيته على الدر المختار”: في “المجتبى”: الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدي والعين والأذن لعلة سواء على الأصح.
وأما إن طرأ على السائل حدث غير المذكور في السؤال كقيء أو جرح خرج منه دم كثير أو حجامة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ للحدث الآخر الطارئ وضوءًا آخر لرفعه، ولا يجزئه الوضوء الأول؛ قال العلامة الحصكفي في “الدر المختار”: إن المعذور إنما تبقى طهارته في الوقت بشرطين: إذا توضأ لعذره ولم يطرأ عليه حدث آخر، أما إذا توضأ لحدث آخر وعذره منقطع ثم سال، أو توضأ لعذره ثم طرأ عليه حدث آخر، بأن سال أحد منخريه أو جرحيه أو قرحتيه ولو من جدري ثم سال الآخر فلا تبقى طهارته.
كما يجب على المريض المعذور التقليل من عذره ما أمكنه ذلك؛ فإذا كان عذره ينقطع إذا صلى جالسًا أو موميًا فإنه يجب عليه أن يصلي كذلك حتى يخرج من حكم ذوي الأعذار؛ قال العلامة الحصكفي في “الدر المختار”: يجب رد عذره أو تقليله بقدر قدرته ولو بصلاته موميًا، وبرده لا يبقى ذا عذر.
هذا بالنسبة لصلاته منفردًا، أما صلاة الجماعة فهي مستحبة عند الجمهور، ويجوز تركه لها قولًا واحدًا على القول بوجوبها؛ لكونه من أصحاب الأعذار.
وأما صلاة الجمعة، فإنه من المقرر في الفقه أن كل ما أمكن تصوره في الجماعة من الأعذار المرخصة في تركها فإنه يرخص في ترك الجمعة، وقد نص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على سقوط صلاة الجمعة عن المريض، ويصليها ظهرًا؛ فأخرج أبو داود في “سننه” عن طارق بن شهاب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»، قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئًا.
وأخرجه الحاكم في “المستدرك” عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد اتفقا جميعًا على الاحتجاج بهريم بن سفيان، ولم يخرجاه، ورواه ابن عيينة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، ولم يذكر أبا موسى في إسناده، وطارق بن شهاب ممن يعد في الصحابة. قال الذهبي: صحيح.
كما أن الجمع بين الصلاتين لعذر المرض جائز عند الحنابلة وبعض الشافعية.
يقول العلامة البهوتي في “كشاف القناع”: يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين العشاءين في وقت إحداهما للمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما.
وقال الإمام النووي في “روضة الطالبين”: المعروف في المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الخوف ولا الوحل. وقال جماعة من أصحابنا: يجوز بالمرض والوحل. ممن قاله من أصحابنا: أبو سليمان الخطابي والقاضي حسين، واستحسنه الروياني. فعلى هذا يستحب أن يراعي الأرفق بنفسه، فإن كان يُحَمّ مثلًا في وقت الثانية قدمها إلى الأولى بالشرائط المتقدمة، وإن كان يُحَمّ في وقت الأولى أخرها إلى الثانية. قلت: القول بجواز الجمع بالمرض ظاهر مختار، فقد ثبت في “صحيح مسلم” أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا. والله أعلم.
مذهب المالكية في حكم الجمع الصوري للمريض
أجاز المالكية للمريض الجمع الصوري بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول الوقت خروجًا من الخلاف في جواز الجمع بالمرض؛ يقول العلامة الخرشي في “شرحه على مختصر خليل”: وكالمبطون ثاني أسباب الجمع أي الجمع الصوري، وليس الحكم مخصوصًا بالمبطون، بل يشاركه فيه كل من تلحقه المشقة بالوضوء أو القيام لكل صلاة، فإن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن منخرق من غير مخافة على عقل جمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر وبين العشاءين عند غيبوبة الشفق.