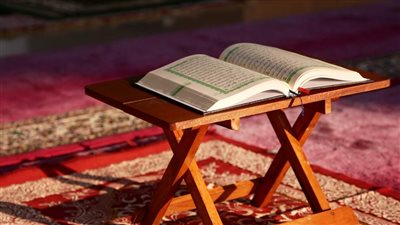هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟... دار الإفتاء توضح

أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه الفتوى؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" رواه الأربعة.
ولا خلاف بين الفقهاء في حِلِّ الأكل من رقبة الإبل.
أولًا: اختلف العلماء في حكم نقض أكل لحوم الإبل للوضوء على قولين:
القول الأول: ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء بحالٍ، واستدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ". رواه الأربعة وصححه ابن حبان.
القول الثاني: ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء على كل حالٍ؛ نيئًا ومطبوخًا، عالمًا كان الآكلُ أو جاهلًا، واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الإبل فقال: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لا تَتَوَضَّؤوا مِنْهَا» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
والجمهور يحملون هذا الحديث وغيره على النسخ بدليل حديث جابرٍ المتقدم، والمختار للفتوى من هذين القولين هو القول الأول، وهو عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل.
ثانيًا: أما بالنسبة لحكم أكل رقبة الإبل فإنه حلال، وليس وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رِجلَه الشريفة عليها -إن ثبت ذلك- دليلًا على تحريم أكلها؛ فقد وضع صلى الله عليه وآله وسلم يده الشريفة على حيوانات أخرى، وركب صلى الله عليه وآله وسلم حيوانات متعددة، وكل هذا لم يحرم أكله، وإنما تأتي الحرمة هنا من النهي عن أكل شيء معين.
دار الإفتاء توضح: القيء لا ينقض الوضوء.. وتجديده مستحب للحامل
أكدت دار الإفتاء المصرية أن وضوء المرأة الحامل لا ينتقض بسبب القيء، سواء كان كثيرًا أو قليلًا، مشيرةً إلى أنه لا إثم عليها في ذلك، مع استحباب تجديد الوضوء حال تيسر الأمر، تيسيرًا على الناس ورفعًا للحرج عنهم.
وأوضحت الدار، في فتوى لها، أن الطهارة شرط لصحة الصلاة؛ فقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...﴾ [المائدة: 6]، كما جاء في الحديث الشريف: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الشيخان.
أراء الفقهاء
وبيّنت الدار أن مسألة القيء كانت محل خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب بعضهم إلى التفريق بين القليل والكثير، معتبرين أن الكثير ناقض للوضوء، بينما ذهب آخرون إلى القول بعدم النقض مطلقًا، وهو ما رجحه المالكية والشافعية، مع استحباب تجديد الوضوء بعده، في حين رأى فريق ثالث أن القيء ينقض الوضوء في جميع الأحوال.
وأضافت الإفتاء أن المرأة الحامل تعاني مشقةً طبيعية خلال فترة الحمل، والقيء من أبرز الأعراض المصاحبة لها، ولذلك كان القول بعدم النقض هو الأوفق لروح الشريعة الإسلامية القائمة على التخفيف ورفع الحرج، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].
كما استندت الدار إلى ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «ما خُيِّر بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا»، مؤكدة أن هذا النهج النبوي في التيسير هو ما يجب أن يُقتدى به في مثل هذه المسائل.
وأكدت دار الإفتاء أن القيء في ذاته يُعَد من النجاسات عند جمهور الفقهاء، غير أن نجاسته لا تعني بالضرورة كونه ناقضًا للوضوء، مشيرة إلى أن القول بعدم النقض مطلقًا هو الأنسب للواقع المعاصر، خاصة مع الحالات التي تتكرر فيها هذه الأعراض مثل الحمل أو بعض الأمراض المزمنة.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن من الأفضل للحامل أو غيرها أن تجدد وضوءها بعد القيء إن استطاعت، لكن عدم فعل ذلك لا يبطل وضوءها ولا صلاتها، داعيةً المسلمين إلى التمسك بروح التيسير التي جاء بها الإسلام، وعدم التشدد في مسائل الخلاف، حفاظًا على مقاصد الشريعة وغاياتها.