دورية "أسطور".. التاريخ السياسي والعسكري والمناهج الحديثة في كتابة التاريخ
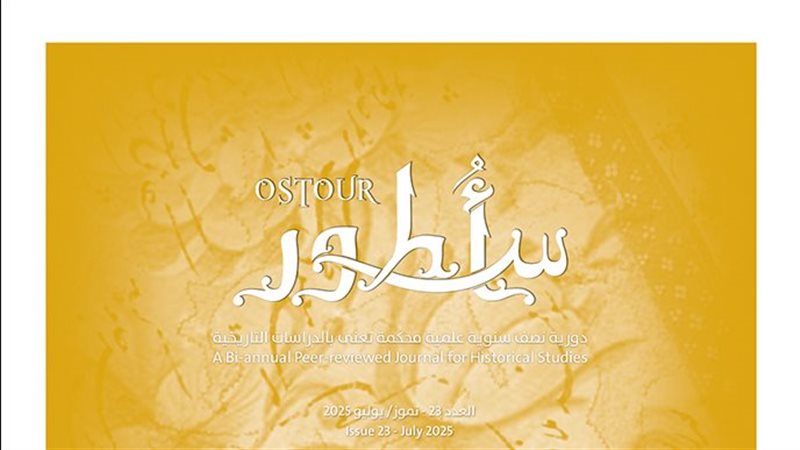
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثالث والعشرون من دورية أسطور نصف السنوية المحكّمة للدراسات التاريخية.
محتويات دورية “أسطور”
وتُقدم الدورية في هذا العدد نخبةً من الدراسات التاريخية، إضافةً إلى ترجمة، ومراجعات كتب تاريخية، ودراسات كلاسيكية، وتستعرض وثائق ونصوصًا، ودراسات من ندوة أسطور أيضًا. وقد ناقش هذا العدد موضوعات في التاريخ السياسي والعسكري، والمناهج الحديثة في كتابة التاريخ، وتاريخ المدن والمناطق، من الناحيتَين الاقتصادية والاجتماعية.
اشتمل هذا العدد، في باب "دراسات"، على الدراسات الستّ التالية: "من هدنة مودروس إلى مؤتمر لوزان: من السلام المفروض إلى السلام الخاضع لإعادة التفاوض" لأوديل مورو، أستاذة التاريخ في جامعة مونبلييه بول فاليري في فرنسا. وتستعرض هذه الدراسة نظام الاحتلال العثماني بعد الهدنة، وأهداف القوى المتحالفة في صَوغ مرحلة انتقالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط. وتتناول مؤتمرات سان ريمو، وسيفر، ولندن، وهدنة مودانيا، والتحضير لمؤتمر السلام في الشرق. وتخلص الدراسة إلى أن معاهدة لوزان أرست نظامًا إقليميًّا جديدًا وأنهت القواعد التي حدّدتها معاهدة فيينا عام 1815.
ويحاول الباحث محمود حداد، أستاذ التاريخ العربي الحديث في جامعة البلمند بلبنان، في دراسة "معاني لوزان عند العرب والأتراك"، البحث في مسار قضية مؤتمر لوزان من خلال مقارنة المواقف العربية والتركية، مفنّدًا مزاعم ضعف النضج السياسي والعسكري لدى العرب مقارنةً بالأتراك. وتربط هذه الدراسة تعثّر العرب بتأثير القوى الكبرى، وتحلّل تحوّل العلاقات بين روسيا وتركيا، وبين العرب والأتراك بعد "سايكس–بيكو"، وتُوضح كيفية إسهام تطورات العلاقات الدولية في إنهاء الحرب لمصلحة تركيا.
ثمّ تَرِدُ الدراسة "إقصاء العرب في لوزان: منعطف تاريخي حاسم" لإليزابيث ف. تومسون، أستاذة كرسي محمد س. فارسي للسلام الإسلامي في الجامعة الأميركية بواشنطن. وتسلّط الضوء على إقصاء العرب عن مفاوضات لوزان على الرغم من حضورهم، معتبرةً أن فهم مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى يتجاوز قضايا الحدود والاستقلال. وتتناول الدراسة الحراك السياسي في سوريا، والإقصاء في مؤتمر باريس، وتحديات نظام الانتداب. وتربط الدراسة لحظة لوزان بإجهاض الطموح السياسي العربي ضمن موجة حركات عالمية مناهضة للنظام الليبرالي والاستعمار الجديد في عشرينيات القرن العشرين.
ويتناول محمد جمال باروت، وهو باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في دراسته "على هامش مفاوضات لوزان اتفاقية صلح عربي حجازي - تركي بعد فوات الأوان"، استبعاد بريطانيا للحكومة الهاشمية بالحجاز عن مؤتمر لوزان، وما ترتب عليه من اتصالات مع حكومة مجلس الأمة الكبير لإنهاء الحرب وإبرام صلح عربي – تركي. ويستعرض موقف الملك حسين المحايد لمصلحة الأتراك في نزاعهم مع بريطانيا حول الموصل، ورفضه مشروع المعاهدة البريطانية – الحجازية. وتخلُص الدراسة إلى أن هذه المواقف قد أدّت، مع عوامل أخرى، إلى سقوط مملكته وتهميشه سياسيًّا في المنطقة.
ويتناول المؤرخ وجيه كوثراني في دراسته "وثيقة تفريق السلطنة عن الخلافة ’الخلافة وسلطة الأمة‘" سياقها التاريخي وتداعياتها في الفكر العربي الإسلامي" هذه الوثيقةَ بوصفها مرجعًا تاريخيًّا وفقهيًّا وقانونيًا مهّد نظريًّا لإلغاء الخلافة بعد معاهدة لوزان. وتستعرض الوثيقة الدعوة إلى فصل السلطنة عن الخلافة وأبرز ما حملته من أفكار، إضافةً إلى تحليلها انعكاسات الفصل، ثم الإلغاء، على الفكر العربي الإسلامي من خلال نموذجَي محمد رشيد رضا وعلي عبد الرازق. وتخلص الدراسة إلى أن الوثيقة أدّت دورًا محوريًّا غير مباشر في بلورة النقاشات الفكرية والسياسية والدينية في العالم الإسلامي.
يختتم باب "دراسات" بـ "نهاية الخلافة العثمانية ومسلمو شبه القارة"، لعزمي أوزجان، وهو أستاذ في جامعة السلطان محمد الفاتح في تركيا، وفيها بحث في التطورات التاريخية والدينية التي أدّت إلى إلغاء الخلافة العثمانية؛ بدءًا من جذورها وفهم العثمانيين إيّاها ودورها داخل الدولة وخارجها. وتحلل الدراسة انعكاسات الإلغاء على العلماء المسلمين والثوار الهنود، ودور رابطة مسلمي الهند في تأسيس لجنة الخلافة المركزية.
وتستعرض "حركة الخلافة" ومساعيها لتعبئة المجتمع الهندي حول القضية باعتبارها شأنًا سياسيًّا يهمّ مسلمي الهند، وتخلص إلى أنّ الإلغاء غيّر المشهد السياسي في الهند، وأضعف الحركة بسبب انقسام قادتها، وهو ما ساهم في تدهور العلاقات بين الهندوس والمسلمين.
أما باب "ترجمات"، فهو يضمّ دراسة ترجمها أنس ريري عن اللغة الفرنسية عنوانها "التاريخ والتحليل النفسي: جينيالوجيةُ علاقة" للمؤرخ والفيلسوف الفرنسي فرانسوا دوس. وتتناول هذه الدراسة تداخل التاريخ والتحليل النفسي؛ إذ تتحول الوقائع إلى نصوص لاواعية تكشف الصدمات المكبوتة لدى الجماعات.
وتسلّط الدراسة الضوء على تركيز التحليل النفسي على العلاقات الخفية بين الظاهر والرغبات المستترة، باحثةً عن المعنى في الفجوات والصمت. ويطرح فرانسوا دوس إشكالية موضوعية التاريخ في ظل خضوعه لقوانين اللاوعي، وحدود القراءة المنهجية لتحليل الأحداث من الناحية النفسية.
ويضمّ باب "مراجعات كتب" مراجعةَ سيار الجميل لكتاب" أتاتورك: سيرة حياته، لكلاوس كرايزر" لسميّة قوزال، ومراجعةَ مثنى المصري لكتاب "وادي موسى والبترا في القرنين التاسع عشر والعشرين" لسليمان علي إبراهيم الفرجات، ومراجعةَ يونس غاب لكتاب" الهزيمة الغريبة: شهادة نُظِمت في عام 1940" لمارك بلوخ، وقد ترجمته إلى العربية عومرية سلطاني.
وفي هذا العدد، استحدثت الدورية بابًا جديدًا عنوانه "كلاسيكيات: أعمال مؤسِّسة" للتعريف بالدراسات الاستشراقية والدراسات العربية الرائدة في مجالها؛ من أجل إخضاعها للنقد العلمي وإبراز مكانتها العلمية في تطوير البحث التاريخي. وفي هذا الباب دراستان؛ الأولى عنوانها "إنجازات صلاح الدين الأيوبي لهاملتون جب"، وقد ترجمها طاهر كنعان، وهي تتناول سيرة صلاح الدين الأيوبي من منظور يتجاوز كونه قائدًا عسكريًّا إلى البحث فيما إذا كانت إنجازاته ثمرة طموح شخصي أم دوافع معنوية أعمق. وتستند هذه الدراسة إلى مصادر معاصرة له، ومنها كتابات علي بن محمد بن الأثير، وبهاء الدين بن شداد، وعماد الدين الأصفهاني، فضلًا عن رسائل القاضي الفاضل. وتطرح الدراسة مسألةً مفادها أن نجاحه اعتمد أساسًا على صفاته الأخلاقية وقدرته على إلهام المسلمين وتوحيدهم، أكثر من اعتماده على مهاراته العسكرية أو الإدارية. وتخلص إلى أن أعظم إنجازاته كان إحياء الوحدة الإسلامية في زمن الانقسام، والسعي لهدفٍ أسمى من السلطة. أما الدراسة الثانية، فعنوانها "هاملتون جب وأعماله عن الإسلام والحروب الصليبية بين مرآة الاستشراق والتاريخ"، لأحمد محمد شعير، وهي دراسة تُقيّم إسهامات هاملتون جب في الدراسات الإسلامية خلال القرن العشرين، خاصة في الحضارة الإسلامية والحروب الصليبية، وتتناول أعماله الخلفيات الفكرية للتصور الغربي عن الإسلام، من خلال منظور تاريخي يحلّل منهجيته في قراءة النصوص. وتبرز الدراسة معالجته لثنائية الروايتين الغربية والإسلامية، وتعيد تقييم مكانته بوصفه مؤرخًا مؤثرًا عبر قراءة نقدية لفكره ومنهجه.
من ناحية أخرى، يتضمّن باب "وثائق ونصوص" دراسة عنوانها "وثائق عثمانيّة حول دار حسين باشا تونس في مدينة إستانبول" لمؤيد مناري. وتتناول هذه الدراسة فترة حكم الباشا التركي أبي محمد حسين لولاية تونس (1591–1596)، اعتمادًا على ثلاث وثائق أرشيفية محفوظة في متحف قصر التوب كابي سراي بإسطنبول.
وتُوضح هذه الوثائق شراءه لعقار فاخر في بشيكتاش يضم طابقين وحديقة وحظيرة؛ ما يعكس رغبته في العودة إلى مركز الخلافة، إضافةً إلى ميل الباشوات إلى الاستقرار قريبًا من مدفن خير الدين بربروس وجامع سنان باشا. وتكشف الدراسة عن الإمكانات المالية الكبيرة لباشوات أوجاق الغرب التي مكّنتهم من اقتناء القصور البحرية على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعاصمة الخلافة والإيالة التونسية.
أخيرًا، يضم باب "ندوة أسطور" ثلاث أوراق؛ أولاها "أهمية منهجية التاريخ التسلسلي والكمي في كتابة تاريخ لبنان" لسعاد أبو الروس، تطرح الدراسة منهجية حديثة لكتابة تاريخ لبنان تعتمد الإحصاءات طويلة المدى والتكامل مع العلوم الإنسانية، بما يعزّز الموضوعية ويحد من خلافات المؤرخين. أمّا الورقة الثانية، فعنوانها "التأريخ للمدن اللبنانية" لخالد زيادة، وهي تهتمّ بتأريخ المدن في لبنان؛ بين تيار فينيقي يربط هوية الساحل بالفينيقية وتيار عروبي يبرز الأثر الإسلامي، مع التركيز على دور الاكتشافات الأثرية والوثائقية، خصوصًا سجلات المحاكم الشرعية، والأبحاث الاجتماعية والأنثروبولوجية المتعلقة ببيروت. وأمّا الورقة الثالثة، التي يُختتم بها هذا الباب، فهي "التاريخ المحلي في جبل لبنان في النصف الأول من القرن العشرين" لسيمون عبد المسيح، وهي تبحث في التاريخ المحلّي في جبل لبنان بوصفه نتاجًا لتطورات اجتماعية واقتصادية وثقافية، معتمدةً المدرسة الوضعية والعلوم المساندة في رصد أدوار بلداته وخصائصها وتحليل واقعها جغرافيًّا وتاريخيًّا.






