العدد 53 من دورية "تبيّن": دراسات في الدولة والعدالة والتقنية والتربية
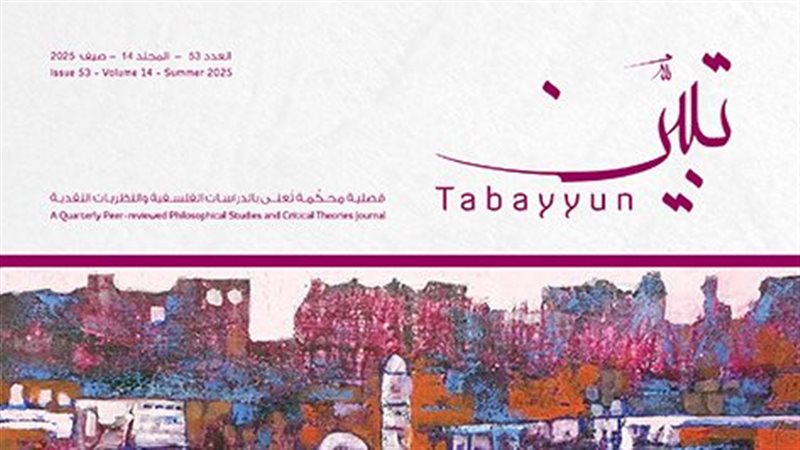
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الثالث والخمسون (صيف 2025) من الدورية المحكّمة تبيّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية. وتضمّن العدد ست دراسات معمّقة، تناولت قضايا فلسفية معاصرة، شملت مفهوم الدولة عند السوسيولوجي بيير بورديوPierre Bourdieu (1930-2002)، وموقف الفيلسوف جون رولز John Rawls (1921-2002) من الإسلام، والتربية في عصر الأنثروبوسين، وإشكالية التأويلية القانونية عند غادامير، ومفهوم الموضوعية في براغماتية ريتشارد رورتي، والتفكيك النقدي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وإضافة إلى ذلك، احتوى العدد على دراسة مترجمة عن مفهوم التسامح، ومراجعتين لكتابين حديثين في الفكر السياسي.
6 دراسات في العدد الجديد من دورية "تبيّن"
افتُتح باب "دراسات" هذا العدد بدراسة لعز الدين الفراع بعنوان "مفهوم بورديو للدولة"، يتناول فيها بالتحليل والتفكيك تصوّر السوسيولوجي الفرنسي بيير بورديو للدولة. تتعقب الدراسة الجذور التكوينية لنظرية بورديو النقدية، بدءًا من تجربته في الجزائر خلال فترة خدمته العسكرية، ومرورًا بتبلورها في السياق الفكري الذي أفرزته ثورة أيار/ مايو 1968. وتبرز كيف استلهم بورديو مقاربات فلسفية متنوعة أو دخل معها في حوار نقدي، ليصل إلى استنتاج مفاده أن الدولة ليست كيانًا قائمًا بذاته، بل هي بمنزلة "حيلة قانونية" أو "تخيّل فقهي". ويرى بورديو أن فقهاء القانون هم الذين أنتجوا هذا "الوهم" القانوني، وفي عملية الإنتاج هذه، أنتجوا أنفسهم بوصفهم طبقة مهنية وسلطة رمزية.
تليها دراسة محمد الرحموني، "أوراق كازاخستان: جون رولز والإسلام"، التي تسعى لاستجلاء موقف الفيلسوف الليبرالي البارز جون رولز من الإسلام، عبر تقديمه ونقده. تكتسي هذه الدراسة أهمية من اعتمادها على أرشيف رولز الذي لم يُنشر في حياته، والذي عمل عليه الباحث مراد إدريس، وهو ما يُعرف بـ "أوراق كازاخستان". ولتقديم فهم شامل، تضع الدراسة موقف رولز في سياقاته الفلسفية والسياسية، مثل تصوّره للعدالة الدولية القائم على فرضية "حجاب الغفلة"، وتطبيقه على قضايا المسلمين كحرب البوسنة والقضية الفلسطينية. وتستند الدراسة، في نقدها موقف رولز، إلى الإطار العام لفلسفته، وإلى المناخ الثقافي السائد في تلك الفترة، الذي هيمنت عليه مقولتا "صدام الحضارات" و"نهاية التاريخ".
ويبحث أحمد صديقي في دراسته المعنونة "التربية في عصر الأنثروبوسين: نحو نموذج تربوي قائم على المسؤولية"، في أزمة التربية المعاصرة في أثناء التهديدات التي يفرضها عصر الأنثروبوسين، الذي تطغى فيه الحضارة التكنولوجية على مناحي الحياة كافةً. تبني الدراسة على رؤية الفيلسوف هانس يوناس Hans Jonas (1903-1993) حول "إيتيقا المسؤولية" لرسم ملامح مقاربة تربوية جديدة. يجادل الباحث بأن النماذج التربوية السائدة، بما فيها النموذج الديمقراطي، أظهرت عجزًا واضحًا في مواجهة التحدي التقني المعاصر. ومن ثمّ، تقترح الدراسة ضرورة تجاوز هذا النموذج نحو آخر قائم على المسؤولية، يكون قادرًا على الاستجابة لشروط الوجود الإنساني الجديدة.
أمّا دراسة محمد شوقي الزين بعنوان "المشكلة النظرية والعملية للتأويلية القانونية عند غادامير"، فتنطلق من فكرة عالمية التأويل التي أقرّها غادامير، حيث يُعدّ كل حقل معرفي ضربًا من التأويل. يركز الباحث على التأويلية القانونية، متسائلًا عن كيفية قراءة غادامير لفلسفة القانون في عصره، وعن الإضافة التي قدمتها فلسفته التأويلية إلى هذا المجال. وتبحث الدراسة في مدى نجاح غادامير في مجاوزة النزعة العلموية التي هيمنت على الممارسة التشريعية، وتستكشف الروابط العميقة بين التأويل القانوني والفلسفة العملية في إطار نظرية شاملة للفعل البشري.
ومن منظور ما بعد حداثي، يتناول محمود العكري وأحمد الفرحان في دراسته "استشكال مفهوم الموضوعية في براغماتية ريتشارد رورتي الجديدة"، المقاربة البراغماتية التي قدمها ريتشارد رورتي Richard Rorty (1931-2007). تبيّن الدراسة كيف سعى رورتي لتخليص الفلسفة من إشكالات نظرية المعرفة التقليدية، وعلى رأسها الادعاء القائل بضرورة تأسيس المعرفة على أساس مفهوم "الموضوعية". تطرح الدراسة تساؤلات جوهرية عن وظيفة الفلسفة، وإمكانية تحويل مسارها إلى ما بعد النظرية، بالتركيز على الفعل الإنساني بدلًا من الانشغال بالثنائيات الكلاسيكية، مثل الذات والموضوع. ويخلص الباحث إلى أن النمط الجديد من التفلسف، الذي يقدمه رورتي، يساهم في تغيير جذري لنظرتنا إلى الممارسة الفلسفية والمفاهيم المرتبطة بها.
ويُختتم باب "دراسات" بدراسة خالد قطب "تفكيك الخلفيات الإبستيمولوجية والأيديولوجية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: مقاربة ناقدة". تتجاوز هذه الدراسة النظرة السطحية إلى الذكاء الاصطناعي، بوصفه مجرد أداة تكنولوجية متقدمة، لتنظر إليه بوصفه "سلطة" معرفية واجتماعية جديدة، تملك القدرة على إحداث تحوّلات جذرية في النظم المعرفية والثقافية. يكشف الباحث عن الخلفيات المعرفية والأيديولوجية الكامنة وراء هذه التكنولوجيا، مبيّنًا التحديات التي تفرضها على طبيعة المعرفة، والعلاقة بين الذات والموضوع، وكيفية إعادة تشكيلها للمجتمعات.
وفي باب "ترجمة"، نقرأ ترجمة منير الكشو لدراسة الفيلسوف الإنكليزي برنارد ويليامز "هل التسامح فضيلة مستحيلة؟". يتساءل ويليامز في هذا النص الإشكالي إن كان التسامح قيمة أخلاقية حقيقية أم مجرد ضرورة ذرائعية. ويوضح أن التسامح نادرًا ما ينبع من احترام أصيل للآخر، بل غالبًا ما يكون نتيجة للشك في امتلاك الحقيقة، أو اللامبالاة، أو توازن القوى. وعلى الرغم من أن الليبرالية تقدم أساسًا مبدئيًا للتسامح عبر قيمة الاستقلال الفردي، فإن ويليامز يشير إلى صعوبة جوهرية: كيف يمكن أن تبرر الليبرالية التسامح لمن يرفضون قيمها الأساسية؟ ويخلص إلى أن التسامح، وإن لم يكن دائمًا فضيلة، يبقى ضرورة عملية في عالمنا المعاصر.
أخيرًا، اشتمل باب "مراجعات الكتب" على مراجعتين: الأولى مراجعة كتاب حدود الليبرالية: التراث، والنزعة الفردية، وأزمة الحرية لمارك ت. ميتشل من إعداد حمدان العكله، والثانية مراجعة كتاب نماذج الديمقراطية لديفيد هيلد من إعداد عمار المحمد، وهما كتابان مترجمان صادران عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وخُتم العدد بعروضٍ لخمسة كتب صدرت حديثًا أعدّتها هيئة تحرير الدورية، وهي تتناول مواضيع مختلفة عن فلسفة الخيال في الفكر العربي، وتعليم الفلسفة، وفلسفة القانون والسيرة الفلسفية لحنة أرندت وهنري برغسون.
أما لوحات العدد، فهي من أعمال الفنان التشكيلي الأردني عصام طنطاوي، المولود في القدس عام 1954، والذي تتمحور أعماله حول تشكيلات المكان، والمدينة وبيوتها، في استكشاف بصري عميق للذاكرة والهوية المرتبطة بالعمران.






