أوقاف المدرسة الصادقية في تونس.. موارد تقليدية لمؤسسة عصرية
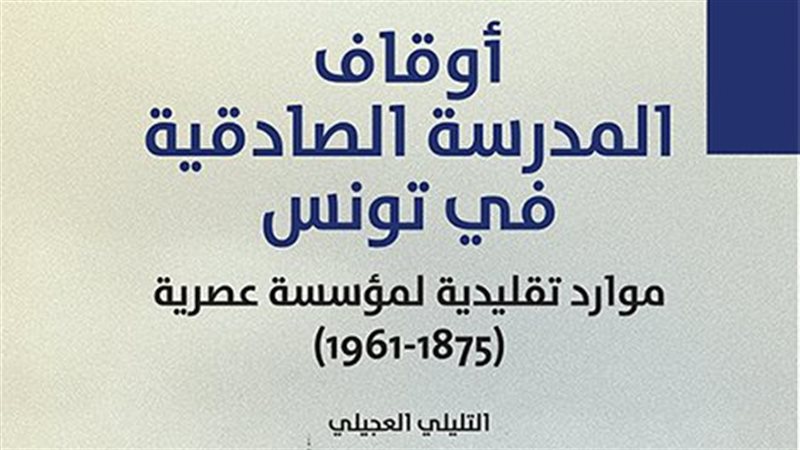
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب أوقاف المدرسة الصادقية في تونس: موارد تقليدية لمؤسسة عصرية (1875-1961)، من تأليف التليلي العجيلي، ويقع في 831 صفحة، متضمّنًا مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة، ومراجع، وفهرسًا عامًّا، إضافة إلى جداول وخرائط وصور، وملاحق.
ويعالج الكتاب مسألة الأوقاف التعليمية من زاوية جديدة؛ إذ يُبرز كيف شكّلت الأوقاف موردًا تقليديًّا حيويًّا لضمان استقلال المدرسة الصادقية ماليًّا وإداريًّا، منذ تأسيسها في عام 1875 حتى عام 1961. فقد كانت أول مؤسسة تعليمية حديثة في تونس، جمعت بين العلوم الشرعية واللغات الأجنبية والعلوم الحديثة. ومع دخول الاستعمار، سُنّت قوانين استهدفت إخضاع الأوقاف العامة لاستغلال المعمّرين، فكان لذلك الأثر السلبي في مداخيل المدرسة واستقرارها المالي. ومع ذلك، واصلت أداء رسالتها التعليمية، محافظةً على استقلاليتها حتى مرحلة متأخرة من الاستعمار، قبل أن تُضمّ أوقافها إلى أملاك الدولة في عام 1961، ضمن إصلاحات ما بعد الاستقلال.
المدرسة الصادقية: تجربة تعليمية نهضوية مدعومة بالوقف
يُبرز كتاب أوقاف المدرسة الصادقية في تونس ما تكتسيه هذه المدرسة من أهمية تاريخية، ليس من حيث نموذجها التربوي الذي جمع بين الزيتوني والعصري وحسب، بل أيضًا لدورها الريادي في تخريج نخبة النخبة من السياسيين والمثقفين الذين تولّوا مقاليد السلطة بعد الاستقلال. وعلى الرغم من وفرة الدراسات التي تناولت هيكلتها وتنظيمها، ظلّ الجانب المالي المتعلّق بأوقافها مغفَلًا نسبيًّا في الأدبيات الأكاديمية، باستثناء إشارات عابرة عند بعض المؤرخين؛ ما دفع المؤلف إلى تسليط الضوء على هذا الجانب، باعتباره ركيزة أساسية في استمرار المدرسة.
اعتمد المؤلف على أرشيف وطني غني، أبرز ما فيه محاضر مجلس إدارة المدرسة الصادقية، التي نُقلت إلى الأرشيف الرسمي في عام 2019. وقد استعان برسوم عقارية حصل عليها من وزارة أملاك الدولة، مكّنته من رسم خريطة دقيقة لأملاك المدرسة الوقفية، وتوزّعها الجغرافي، ومساحاتها، وتواريخ تسجيلها، ومجالات صرفها. أتاح هذا المسح الوثائقي الشامل فهمًا أعمق لكيفية أداء المدرسة وظيفتَها التعليمية بتمويل ذاتي، قبل أن تُدرَج تباعًا في السياسة التعليمية الفرنسية، إلى أن أُخضعت إداريًّا وماليًّا للدولة بعد الاستقلال.
الصادقية في سياقها الإصلاحي
يبيّن الكتاب أنّ تأسيس هذه المدرسة جاء ضمن مشروع إصلاحي واسع النطاق، ارتبط بوعي تونسي مبكر بضرورة تحديث المؤسسات التعليمية، في أثناء التهديد الفرنسي لها والضغوط الداخلية عليها. وقد مهّدت إصلاحات الجيش، وإنشاء المدرسة الحربية بباردو، لظهور طبقة إصلاحية مستنيرة، تُوِّجت بتولّي خير الدين التونسي زمام السلطة في عام 1873، الذي استلهم نموذجه من التجربة الأوروبية، كما فعل محمد علي في مصر، فرأى في التعليم العصري أداة مركزية للنهوض. ضمن هذا السياق، وُلدت المدرسة الصادقية في عام 1875، فجمعت بين الأصالة والمعاصرة، وبين العلوم الشرعية والمعارف الحديثة، وسُندت بأوقاف وفيرة ضمنت استقلالها ودوامها.
غير أن الاستعمار الفرنسي، منذ دخوله في عام 1881، سعى لإخضاع المدرسة لإرادته عبر سياسات تربوية تدرّجية، تمثّلت في فرض اللغة الفرنسية، وتعيين مدير فرنسي، وتوجيه مناهجها، وضرب قاعدتها المادية بفتح أوقافها أمام الاستغلال. ومع ذلك، حافظت المدرسة على شيء من استقلالها، وحظيت بدعم حكومي منذ عام 1920. لكنّ نقطة التحوّل جاءت بعد إنشاء "مجلس الإتقان" عام 1906، الذي أوصى بتحديث البرامج التعليمية، فسمح بإعداد تلامذة يُؤهّلون لشهادة البكالوريا ومتابعة التعليم العالي. من هنا، برزت نخبة جديدة أكثر تنوّعًا، تضم اختصاصيين في القانون والطب والهندسة والتعليم، بدلًا من الاقتصار على الوظائف الإدارية التقليدية.
من نخبة الدولة إلى تهميش الوقف
يتطرّق الكتاب إلى إثبات هذه المدرسة لفاعلية نموذجها، حينما شكّل خرّيجوها ما نسبته 65 في المئة من النخبة السياسية في الفترة 1955-1969، كان منهم الحبيب بورقيبة نفسه، و124 وزيرًا من أصل 137 في الفترة 1956-1987. وقد ساهمت الأوقاف، ليس في تمويل المدرسة فحسب، بل أيضًا في "دمقرطة" التعليم؛ ذلك أنها وفّرت الدعم المالي لتلامذة من مختلف مناطق البلاد، بمن فيهم أبناء الجهات المهمّشة.
غير أن المفارقة تجلّت في أن عددًا من خريجي المدرسة أنفسهم كانوا من أبرز الداعين إلى إلغاء الأوقاف، على الرغم من أن هذه المؤسسة العريقة هي التي صقلتهم علميًّا ودفعتهم إلى مواقع القيادة. وبُعيد الاستقلال، سارع النظام الجديد إلى تصفية الأوقاف، وإلغاء الجمعية العامة التي كانت تشرف عليها، واعتُبِرَت أوقاف الصادقية "عامةً"، على الرغم من وجود فتوى استثنتها من ذلك، ليُصار إلى ضمّها رسميًّا إلى أملاك الدولة في عام 1961، حين باتت ميزانية المدرسة تحت إشرافها المباشر.
ويخلص المؤلِّف إلى أن نظام الوقف، بما يمثّله من استقلالية أهلية وتمويل ذاتي، أثبت نجاعته في خدمة التعليم والتحديث. لكن لأسباب أيديولوجية – تتعلق بالنزعة اللائكية وموقفها من الدين – واجه الوقف مقاومة شرسة في تونس المعاصرة، حتى في محاولات إحيائه كما حصل في عام 2013، حين أُسقط مشروع قانون لإعادة العمل به، في ظل اتهامات مبطّنة لمؤسسات الوقف، وللإسلام ذاته أيضًا.







